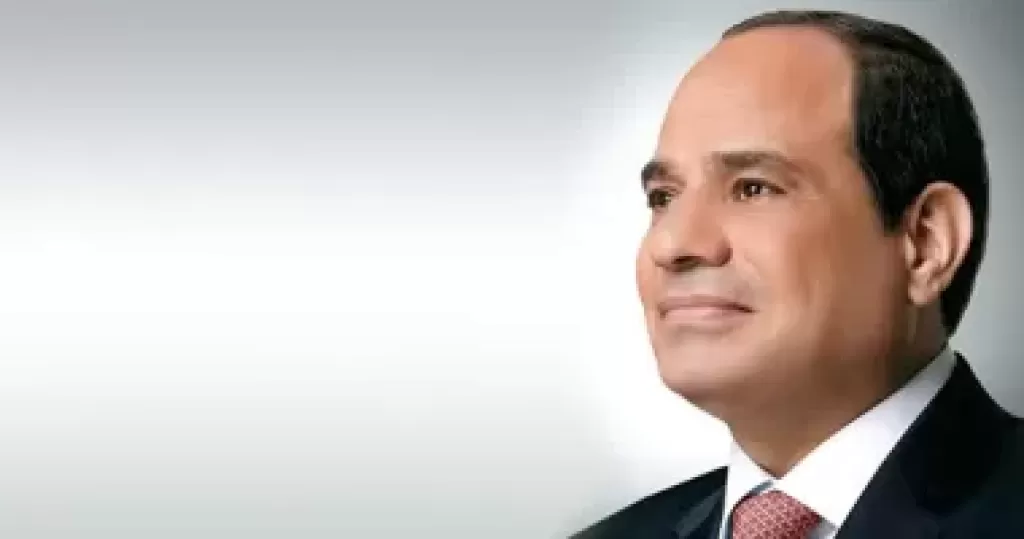الإعصار جند الله

على الرغم من التقدم العلمى المذهل الذى بلغته الإنسانية،
فى مختلف ميادين المعرفة والثقافة، بل وسائر المجالات
الحياتية فهى تقف عاجزة أمام الظواهر الطبيعية مجرد
أن تتأمل فيها وتحصد نتائجها، تلك الظواهر التى يعقبها
عادة آثار مدمرة تبلغ حد الكوارث.
صحيح أنها قد تملك القدرة على التنبؤ بها، والتحذير منها بل ولفت نظر
الناس إليها، بما أوتيت من علم وبلغت من معرفة، إلا أنها لا تستطيع مطلقًا
أن توقف مداها أو تقلل خطرها أو تحد نشاطها أو تغير وجهتها.
ولعل أكبر دليل على ذلك، ما يحدث فى العديد من الولايات بدولة بحجم
الولايات المتحدة الأمريكية، بما تملكه من القدرات والإمكانيات المذهلة علميًا
وماديًا إلا أنها تقف شبه عاجزة عن التعامل مع تلك الظواهر الطبيعية
العاتية والسؤال الذى يطرح نفسه....
أى معنى من وراء هذه الظواهر وأى غاية فى حدوثها؟
وإذا كانت هذه الظواهر شر فكيف نستطيع التغلب عليها
أو الحد منها؟؟؟؟؟ أسئلة كثيرة تجتاج العقل البشرى إزاء
تلك الظواهر، وخاصة عندما تخلف وراءها الآثار المدمرة
والنتائج المخيفة، من فيضانات وتخريب وخسائر مادية
وبشرية لا حصر لها.
وإزاء هذه الأسئلة المتداخلة يمكن للعقل الإنسانى أن يهتدى إلى أمر قد
يتشكك فيه أو قد يصل إلى نتيجة كثيرًا ما يغفل عنها، وهى أن هذا الكون لا
يسير على وتيرة واحدة، ولا يمضى وفق إرادة أحد مهما بلغ من قوة وشدة،
بل يتحرك وفق مشيئة ليس لها حد، وليس لها مد أنها إرادة الله المطلقة
وكلمته النافذة فى الوجود، فلقد شاءت قدرته أن يبتلى الخلق ويختبرهم،
حتى يميز الخبيث من الطيب منهم، كما شاءت قدرته أن يجعل بين كل محنة
منحة، وبين كل شر خير، ودائمًا يأتى اليسر عقب العسر، كما أن الأيام دول.
تلك حقائق ينبغى أن تكون جديرة بالاعتبار والاهتمام
ونحن نواجه الصدمات على مستوى الأشخاص أو الدول،
وخاصة فى وقت الأزمات، ومن هنا نقول إن ما يحدث فى
هذا الكون من آيات تهز المشاعر وتحرك الأبدان كالصواعق
والرياح الشديدة والأعاصير والفيضانات والبراكين وما
تسببه من هلاك ودمار، وما يقع من خسوف أو كسوف
للشمس أو للقمر أو نحو ذلك مما يبتلى الله به عباده، هو
لحكمة جلية ولغاية ربانية، ينبغى على الإنسانية أن تقف
معها وتسعى من أجل أن تتفهمها، لذلك عندما قال الناس
فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، كسفت الشمس لموت
إبراهيم، فخرج النبى صلى الله عليه وسلم عليهم وخطب
فيهم خطبة بليغة وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من
آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لأحد ولا ينخسفان.
ولعل هذه الحقيقة تعطينا انطباعًا على واجب الإنسانية إزاء نعم الله عز
وجل التى لا تعد ولا تحصى، والذى يتحقق بشكر واهب النعم.
كما تمنحنا فرصة حتى نراجع أنفسنا ونصحح أوضاعنا ونلملم شعثنا.
ونستوعب الدرس الأكبر فى هذه الحياة، وهو أنه مهما
بلغت قوة الإنسان فإنه لن يستطيع بمفرده أن يحيا، كما
أنه لن يستطيع أن يواجه عثرات الحياة وكوارث الطبيعة
إلا إذا كان تحت مظلة من قيمة نفيسة، أو من وطن عزيز أو
من صحبة طيبة أو من أسرة نقية العاديات.
ولعل الدرس الأكبر الذى ينبغى على الإنسانية أن تستوعبه من جراء
الأحداث التى تمر بها هو الوقوف على حقيقة الكون، وعلى طبيعة الأرض
فهذه الأرض التى نحيا عليها ليست جثة هامدة بل على العكس تمامًا إنها
حية تتنفس وتتحرك وتنبض.
هذه الحقائق أثبتها العلم، فالزلازل التى تحمل فى
ظاهرها نقمًا شديدة وأخطار عظيمة تمثل نبضات قلب
الأرض، وإكسير يجدد شبابها، وهكذا الحال بالنسبة
للأعاصير فعلى الرغم من صعوبة حصر الخسائر، التى
جرت على الإنسانية من ورائها خلال القرن الماضى والتى
تبلغ الكثير والكثير من الأنفس والثمرات إلا أنها تحمل
فائدة عظيمة، يغفل الناس عنها من نقل الطاقة الفائضة
من المناخ، من حفظ التوازن فى الكون، من جلب الأمطار
التى تعد من الأهمية العظمى فى هذه الحياة من تلقيح
للزروع والثمار.
إن حكمة هذه الأعاصير وتلك الزلازل ينبغى أن تفهم من ضوء هذه
الحقائق، وهذا يتطلب بالضرورة من كل عاقل أن يثوب إلى رشده وأن يدرك
حجمه وأن يعرف قدره وأن يعود إلى خالقه، وعلينا جميعًا أن ندرك قول الله
تعالى فى كتابه العزيز (إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع
وهو شهيد).





















![الكاتبة إلهام شرشر تكتب: الدروس المستفادة من قصة الخليل [عليه السلام] الكاتبة إلهام شرشر تكتب: الدروس المستفادة من قصة الخليل [عليه السلام]](https://admin.elzmannews.com/img/22/07/09/416146_L.jpg)